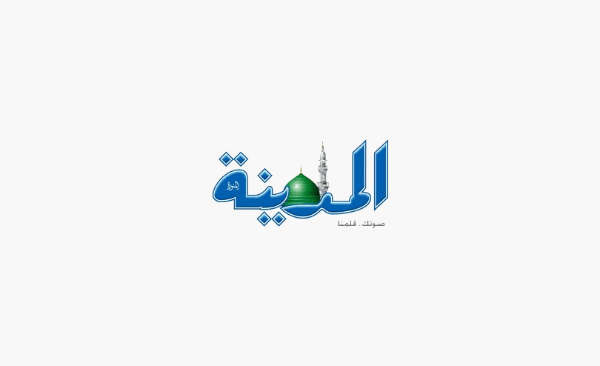نلتقطُ صورًا لأجمل اللحظات، لأسفارنا، لطعامنا، لأطفالنا، لمنازلنا، وملابسنا، وحتَّى حيواناتنا.. لكنَّها تبقى صورًا بلا روح، بلا مشاعر، تفتقد العفويَّة، ولا تعبِّر عن الحقيقة؛ لأنَّها مصطنعة...
استوقفتني صورةُ طفلة الموصل، وتحجَّرتْ مدامعي وأنا أتأمَّلها.. ابتسامةٌ مخنوقةٌ بالعَبْرة، وعيونٌ عسليَّةٌ مكتنزةٌ بالدموع، وشعرٌ بنيٌّ تطايرت خصلاته، شفاهٌ مزمومةٌ تكتمُ شهقاتٍ وعبراتٍ، تعبيراتُ وجهها البريء تقول الكثير من البؤس والألم والخوف.
صورةٌ واحدةٌ لطفلةٍ نقلت معاناة شعب يتعرَّض للتصفية! مجزرة الموصل تودي بحياة أربعة آلاف مدني، جلُّهم من الأطفال والنساء. يعيش أهالي الموصل اليوم حالةً من الخوف والهلع، فهم بين مصيرين: إمَّا الموت بالرصاص، أو الهدم، وإنْ هم فرُّوا كان مصيرهم الشتات، والجوع، والمرض.
لقد استحوذت صورة طفلة الموصل على اهتمام المغرِّدين، وانهالت التغريداتُ المتعاطفة معها، ودبجت القصائد في وصف حالها، وحال أهلها، وكُتبت المقالات -ومقالي هذا أحدها- في محاولة لنصرة أهلنا في العراق، وتسليط الضوء على معاناتهم، ولتصعيد مأساة المهجَّرين قسرًا، وما آلت إليه الأوضاع، من إبادة لشعبٍ أعزل وتهجيره.
إن فورة هذا البركان يجب أن لا تهدأ، أو تخمد نيرانها، فقد أصابنا الخوار والضعف ممَّا وصلت إليه حال الأمة من حروب ونكبات.
نحتاج أن ننفضَ الغبار الذي علا رؤوسنا، وأوهن عزيمتنا، ونهبَّ لنصرة إخوتنا المستضعفين، ونوقف نزف جراحهم، وندفع عنهم السوء، ونرفع عنهم الظلم والقهر، هذه الموصل، وبالامس حلب، وقبلها غزة، مآسٍ يدفعُ بعضُها بعضًا.