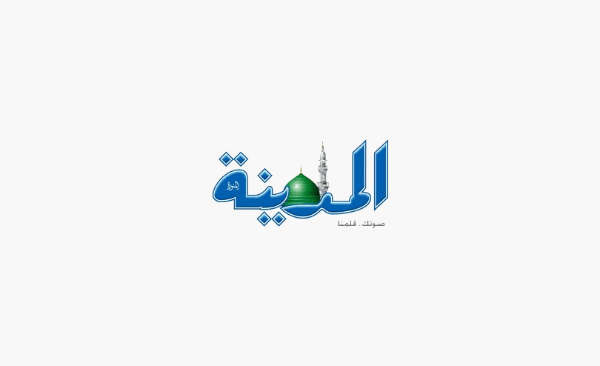نعم.. بدايات الصباح رواية من نوع آخر.. ليست رواية تختص بأحد معين.. بل تختص بجميع من على وجه البسيطة.. فنسمات الصباح الأولى تُمثّل تلك المقطوعة، التي يتغنى بها أصحاب النظارة الطبية.. وأمامهم إفطارهم المكون من قطعة كروسان مع عسل وقشطة وكأس من عصير البرتقال، وعلى طرف الطاولة جريدتهم، التي تعودوا على قراءتها كل صباح..
بالجانب الآخر تتعالى أصوات الطلاب، فاليوم هو آخر يوم من الدراسة؛ منتظرين الباص المعروف ببوقه المرتفع.. وفي ردهة من جانب المدينة تقطن قلوبًا تتألم شوقًا.. نعم الألم اللذيذ المتخزن في فؤاد فتاة العشرين، التي ترقب الطلاب وخطواتهم من أعلى البناية في الدور الثالث واقفة على الشباك ممسكةً بطرف الستارة.. وأثر السهر على عينيها.. تنتظر فارسها، الذي لم تصل منه رسائل منذ زمن..
فصلا آخر من رواية الصباح المحبوكه؛ لتلك الأم التي تلازم الكوخ الريفي الذي أكل الزمن عليه وشرب.. بجانب حظيرتها الملاءة ببعض المواشي والطيور والديك، الذي يصدح معلنًا صباح يحمل في طياته لحظات.. ذكريات.. أمنيات.. وكل شيء جميل.. ولا ننسى بائع الورد فللصباح نصيب من مقطوعته..
وفي نهاية الطريق المؤدي إلى مدينة أخرى يقطن شاعر أديب انفرد في مكتبته الكبيرة مصاحبًا كتبه بين الفينة والأخرى سخروا منه منذ بداية جمعه للكلمات.. وتأليفه للكتب.. وحين رفعته حروفه.. وتغنت الصحف بكلماته.. ذهبوا إليه يسألوه كيف نجحت في ذلك..
نعم.. محدثتكم صاحبة المكتبة المركونة على جانب المدينة.. وكلماتي هي التي وصلت!!.. ومن حولي هم الذين سألوني كيف نجحتِ في هذا؟.. مع العلم هم أول من سَخِرْ.. وحين النجاح.. أول من انبهر..
في النهاية؛ اُجمل روايتي الصباحية: (إذا سَخر منك أحد.. فخذ كلامه دافعا لفعل ذلك الأمر.. سيأتي ويقول لك: كيف فعلت ذلك!! قل له: أنت من أوصلني إلى ذلك.. واذهب واتركه يغوص في دشته.. كيف ساعدته؟).